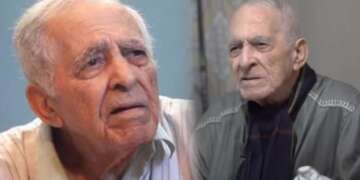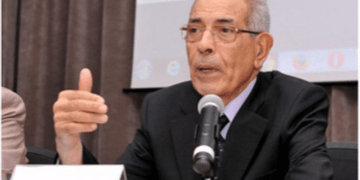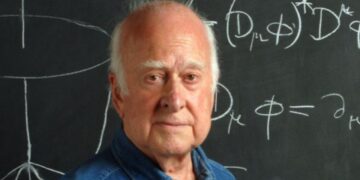ادريس هاني
عن سن يناهز 86 عاما، ترجّل المفكّر العربي الكبير د. حسن حنفي، يوم الخميس(21/10/2021)، بعد أن ملأ الدنيا وشغل العالم بطروحاته الجريئة، لاسيما، خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. تلك إذن سنّة الحياة، غير أنّ رحيل هذا الصنف من المفكرين الكادحين الذين أفنوا أعمارهم في البحث والتّأمّل، معتمدين على قوة أفكارهم، يستحق وقفة، وتذكّرا، وفاء للفكر والمفكرين قبل الوفاء للصداقة والأصدقاء، حيث الموقف الأخلاقي يقتضي أن نقول عنهم كلمة في لحظة الفراق الصّعب، ننعاهم بوجع الفراق، ومشاعر الإنسان الحقيقية ونُبل الأحاسيس، ورفعي الذّوق؛ أولئك الذين تفانوا في خدمة المعرفة في تواضع ونكران للذّات في حياتهم، وجب إكبارهم في مماتهم كما يستحقون وكما يمليه منطق الأشياء.
خلال هذه العقود الممتدة، كانت أطروحة التراث والتجديد وما تفرّع عنها من مشاريع أوَّلُها اليسار الإسلامي وآخرها علم الاستغراب، أو بتعبيره في آخر حوار عن اليسار الإسلامي: محاولة تجسير بين الشيوعية والليبرالية عن طريق الإسلام المستنير. والحقّ أنّها دعوة نسقية أكثر مما هي محاولة الجابري في الكتلة التاريخية؛ الجابري جزّأ معرفيا ودعا للوحدة سياسيا، لكن حنفي حاول إيجاد الجسور من داخل المعرفة، أي كتلة تاريخية معرفية إن شئت القول.
آمن بالتغيير، وآمن بالأفكار الثورية لليسار الهيغلي وبالتالي الماركسي، غير أنه سلك مسلك دعاة التركيب، يسار متصالح مع الموروث المحلي بعد إعادة إنتاجه على أصول التجدد والاستنارة. آمن حنفي ، ولعله من أوائل من آمن بلاهوت التحرير، حتى أنّ تنظيره يكاد يكون ضربا من التنزيل العربي لهذا الفكر. دشن مشواره بالتراث والتجديد، وكنت دائما أرى “التراث والتجديد” كمقدمة لمشروع حنفي في إعادة تأويل التراث، بمثابة “نحن والتراث” كمقدمة لنقد العقل العربي عند الجابري، وإن كان هناك اختلاف كبير في المضمون: أحدهما آمن بالقطيعة بينما الثاني آمن بإعادة تأويل التراث على أسس الاستنارة.
ترجّل الفقيد و- هو حتى آخر رمق- كان مأخوذا بأسئلة العقل والتقدم والتجديد، وقد كان من جيل الرواد المؤسسين للتيار النّقدي، لا يمكن الحديث عن هذه الحقبة دون أن يطفو على السطح، ومهما اختلفت مع د. حسن حنفي، لا تستطيع أن تلغي حضورا مكثّفا وجدلا مفتوحا كالجداول، ومفكّرا عاش للفكر وتقاسم بنات أفكاره بصوت عالي مع المحيط بلا تردد ولا وجل.
تعرّفت على أفكار الفقيد في وقت مبكّر، لأنّها شغلت المجال العربي ردحا من الزّمن، وتناولت آراءه بالقراءة وأيضا بالنقد على امتدادا ثلاثة عقود، وسأفرد له مساحة كبيرة في كتابي : العرب والغرب(1998-دار الطليعة) وفي كتابي أيضا: خرائط أيديولوجيا ممزقة(2006_مؤسسة الانتشار العربي)، وقبل ذلك في مطلع التسعينيات، في دراسات ومقالات مطوّلة.
لكنني سأتعرف عليه عن قرب فيما بعد، عبر محطّات كثيرة، وفي سياق تأطير عدد من المداخلات في ملتقيات تتعلّق بقضايا متنوعة يجمع بينها شاغل النهضة والتنوير. سأكتشف فيه قبل الفكر وبعد الفكر، ذلك الرجل الذي يتحلّى بنزعة أبوية وروح دمثة، والأهم فيما لمسته منه هو أنّه يفكّر من دون حقد؛ يسافر بفكره بشجاعة ناذرة، لا يقف عند الحدود، ويشفع له في كل هذه المحاولات، مباشرة التفكير من دون اعتمال نفسي. سأكتشف رجلا سويّا، بفكر يسافر من الأقصى إلى الأقصى، وكالحلاّج، يَعْلَقُ في الذّروة ويتعذّر عليه النزول، فنصيبه من الفناء يكمن في صلب نزعته الواقعية نفسها، هو يهوى التداني، ويفنى فيه؛ حتى لطالما كنت أصف وضعيته من باب المجاز: من الفناء إلى البقاء بالفعل، وهو عنوان كتابه، لكنني أراه لم يخرج من فناء الواقعية المثالية. هذا مع أنّه يعتبر في نظري مفكّر النزول، والتداني، والواقع، حتى أنّه أنزل كل مثال إلى الواقع، حتى الفلسفة جعلها تركض على طريق الواقع، وكل شيء، كشريعتي، بات في خدمة الثورة والتغيير، لكن السؤال الذي لا زال لم يطرح ووجب أن يطرح في سياق القراءة الحيوية لمشروع الراحل حسن حنفي هو: أي واقع نريد؟
أذكر أنني كنت أحدّثه ونحن نغادر مكتبة الأسد بدمشق قبل سنوات، وكان الحديث ودّيا، وفجأة سألته إن كان نقدي لبعض آرائه يشكّل حرجا أو إزعاجا؟ وسأفاجأ بتسامي كبير وأيضا تحريض بيداغوجي على استمرارية الحياة النقدية، قال لي رحمه الله: لا بدّ من النقد، فلولا هيغل لما كان ماركس.
استمرت العلاقة مع الفقيد، باللّقاء والمراسلة، مع أنّ المرحوم وعلى الرغم من دعوته للتجديد، كان متبرّما من وسائل التواصل الحديثة، وأسرّ لي بأنّه شيخ كبير، يعتمد على الغير في تدبير التواصل الإلكتروني، فلم يتردد في التجاوب والاستشارات، وحين صدر كتابه التأسيسي حول مقدمات في علم الاستغراب، قدمت حينها فورا، في تسعينيات القرن الماضي، أطول قراءة مستوعبة لتفاصيل هذا العمل الذي مثّل إضافة قيمة للمكتبة العربية على صعيد نقد الغرب.
في بعض الملتقيات، وحين كان يحتدم النّقاش، كما حدث بيني وبين أحد الزملاء مرّة، تدخّل ليؤكّد بأنّ النقاش مشروع، وسعى بأبوية لإطفاء الحرائق. والحقّ أنّه لم تكن هناك حرائق، وإنما لما رآني غاضبا من تعليق أحدهم، حاول أن يخفف عنّي. كان هناك متدخل وهو أب مسيحي أيضا سيصبح صديقا ودودا، أراد أن يمرر موقفا ضدّ أحدهم، فاختارني حائطا قصيرا لذلك، فوجه ملاحظته ضد غريمه من خلالي، لكنني قلت له يومها: لست حائطا قصيرا، وعليك أن تحترم نفسك كأب، وغادرت القاعة، لكن المرحوم حسن حنفي لحق بي وهو ينادي عليّ، لكن وجدني مع الأب نتبادل الحديث ودّيا، فبدت على وجهه علامة الرضى، وكأن لسان حالة: هذا جيد. لم يكن عندي إشكال فيما لو أنّ صديقي الأب اتفق معي مسبقا على تمرير رسالة نقد لغريمه، من باب إياك أعني واسمعي يا جارة؛ كانت أيّاما جميلة، وبرفقة رجل في قامة حسن حنفي هي لا شكّ أجمل، لأنّه كان يَشعُر كما كان يُشعِر من حوله، أنّه أب ومسؤول عمن حوله. وحين تجاذبنا أطراف الحديث مرّة، وكان يتحدّث يومها عن وضع مصر والوضع العربي، علّق أحدهم بطريقة لم تعجبنا يومها، حيث قال له: هذا وضع كل البلاد العربية، لماذا تتحدثون عن مصر فقط؟ كنت أنتظر أن تكون له ردة فعل قوية، لكن وبكل هدوء ردّ على تعليق ذلك الشخص بالقول: نعم، ولكن مصر هي الشقيق الأكبر. لم يقلها تحدّيا ولكن قالها حسرة، وقد تركت تلك العبارة انطباعا عميقا في نفسي، ولا زلت كلّما رأيت مصر تذكرت هذه العبارة: إنّ الأزمات التي تعصف بالشقيق الأكبر تكون مؤلمة. وحين زرت مصر ذات مرة، وأخطره بعض الزملاء بوجودنا ورغبتنا أيضا في لقائه على هامش بعض الفعاليات، فاجأني بالاتصال على الهاتف، متأسّفا كونه كانت ذروة الحرّ، ومعروف على أهل القاهرة في فصل الصيف، مغادرة القاهرة إلى الشمال وإلى الإسكندرية، وبالفعل لقد كان الحرّ شديدا وكانت مصر يومها تغلي وهي تتجه نحو المجهول على أعقاب حوادث ما عرف يومها بأحداث الربيع العربي وسقوط نظام حسني مبارك. وكنا نريد يومها أن نعرف منه شخصيا رأيا حول الأحداث، لكن القيظ حال دوننا وذلك.
وجب التذكير، بأنّ د. حسن حنفي مفكّر من الجيل الأوّل، ووجب أيضا احترام المسافات، لأنّ الخلط بين الأجيال هو شكل من النّصب والاحتيال، فالرجل خاض غمار العلم في وقت مبكّر كان الكثيرون غاطّون في سبات من الشرود والضياع، فالأكتاف متساوية ولا العين تعلو على الحاجب كما يقول المثل المغربي، ففي بدايات الثمانينيات أصبح أستاذا في المغرب قبل أن يغادر إلى اليابان ليباشر التعليم. يصدر حنفي من جيل ثقيل بكل ما تعني الكلمة من معنى، جيل صناعة المعنى. كان حنفي صارما فيما يعني أصوله في التفكير ومواقفه التي لا يتزحزح عنها قيد أنملة، وفيما عدا ذلك فهو رجل مجاملات. والحقّ: وجب أخذ آرائه الصارمة بجدّ، وآخذ مجاملاته مسامحة.
وكان للمرحوم مطلبان استملحتهما:
أولا_ أنّ المداخلين يجب أن يلخصوا ورقتهم، فهي ما دامت ورقة من بنات أفكارهم، فيمكن تلخيصها شفهيا حفاظا على الوقت المقرر.
ثانيا_ كان يعتبر النقاش في أي ملتقى هو من نوع الجدل لا البرهان، هكذا يعبر بالمصطلح الكلامي، أي لندع العروض التي تشبه الدروس المقررة، وندخل في جدل فكري وحجاج مفتوح ونترك الأفكار المدرسية في المعاهد والجامعات.
حينما كلّفت بوضع التّصور العام لإحدى الأحزاب السياسية في بلادنا، كنت مصرّا على منح المثقف دورا في العملية السياسية، على الأقل كان هذا هو الطموح والمأمول، كان هناك عزوف كبير للمثقف عن الانخراط في السياسة، ومعظم المثقفين من الجيل الأوّل الذين ارتبطوا في البداية بالأحزاب، جمّدوا عضويتهم تحت مبرر التفرغ للبحث العلمي. كانت رؤيتي يومئذ أنّ هذا أمر خاطئ، لكنني سأدرك فيما بعد ومن خلال أصدقاء كثر فضلوا العزلة، أنّ موقفهم صحيح، وهو شكل من الاحتجاج أيضا، والسمو بكرامة المثقف.
وقد غاب عن قيادة الحزب المذكور يومها، بأنني لم أسلم الورقة المذهبية إلاّ بعد أن عرضتها على عديد من الأصدقاء ومنهم حسن حنفي، حيث اطلع عليها بشكل دقيق وأبدا لي بعض الملاحظات التي تتعلّق بقناعاته الفكرية والسياسية، الجميل هو أنّه عبّر لي عن رأيه بصراحة، وكان أيضا لا يخفي مديحه للمغاربة وحبهم للعلم والتحقيق، حيث لا زال يذكر تلك السنوات التي قضاها أستاذا زائرا للفلسفة بجامعة فاس. لقد كان يومها حالة فارقة في زمن الاصطفافات الأيديولوجية الحادّة، كان هو خلافا للكثيرين في برزخ ينحت فكره بين التخوم، في محاولة تركيبية تجمع بين النزعة الشيوعية والإسلام، في منحوتة اليسار الإسلامي. والحقيقة التي لم يلتفت إليها يومها، هو أنّه بقدر ما ترك له آثارا من ذاك القبيل إلاّ أنّه واجه معارضة من داخل الجامعة نفسها، قادها قسم من اليسار، لا سيما الاتحادي، الذي لم يكن يقبل بهذا المزيج. لكن الفقيد واصل التنظير لليسار الإسلامي، حيث لم يُوفق في تأسيس تنظيم بهذا المعنى، لكن أفكارا كثيرة انتشرت واخترقت اليمين واليسار، وربما كانت تلك هي غايته، ومنها التخفيف من وجع الاستقطاب وإعلان مصالحة تاريخية بين الشيوعية والإسلام، أو بالأحرى بين فهمين لهما، وكان لا بدّ أن يدفع استحقاقات المغامرة، من صنوف التكفير. وقد حكى لي بعض الأصدقاء الذين ساهموا في تلك المواجهة الأيديولوجية، في زمن ما يمكن أن نسميه بعصر الأيديولوجيات الكبرى في جمهورية اليسار في جامعة ظهر المهراز بفاس، معقل اليسار الراديكالي، لا سيما شعبة الفلسفة: شعبة تكاد تكون شعبة خالصة للاتحاديين. والجميل في الفقيد حسن حنفي أنّه كما ذكرت، لا يأبه بالآثار النفسية للنقد، هو أيضا له قدرة فائقة على الفصل بين الفكر باعتباره نشاطا عقليا وبين الانفعالات النفسية، هذا مع أنّه يؤمن بالنهضة والثورة والتغيير.
لعلّ آخر مرة صادفته فيها، أثناء تأطير مداخلات حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية للربيع العربي، قبل ثماني سنوات في باكو، نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية التابع لرئيس الجمهورية، وهناك قضينا أوقاتا طيبة، وانفردنا بجلسات تابعنا فيها ما كان يجود به الخاطر، وكان قبلها بسنوات مضت، قد طلب مني تزويده ببعض كتبي، لأنه كان ينوي إصدار كتاب حول الأفكار والاجتهادات للجيل الجديد في الفكر العربي، وهو العمل الذي لم أعرف مصيره، لكنني لمست منه اهتماما فائقا بتطور الحركة النقدية في المجال العربي، وكانت عينه على كل جديد، وكان متطلّعا للمستقبل.
لكنه انتابني شعور في لقاء باكو مؤلم، لقد تدهور وضعه الصحي إلى حدّ أنّه بات يستعمل كرسي متحرك؛ كنا نتجول أحيانا، وكنت أسوق به الكرسي ونتحدث قدر ما يسمح به وضعه الصحي أنذاك. على هامش العرض، وبعد تقديم المداخلات، كان حسن حنفي يقوم بواجب التقييم والتعليق والنقد كعادته، وكان أحد المداخلين المتخصصين في البرمجة اللغوية العصبية له ميول إخوانية قد أثارت حفيظة بعض الإخوة المصريين، الذين لم يخفوا امتعاضهم والاحتجاج بشراسة عن محتوى مداخلته، لكن حسن حنفي على طريقته هدّأ من روعهم، ولكنه في الوقت نفسه زرع تحت قدم المُداخل المذكور قنبلة أخطر من تلك الاحتجاجات، وذلك حين قال لهم، إنّكم تظلمون الأخ فلان، حينما تحاسبونه على كيت وكيت، وكان المداخل قد افتتح كلامه بالقول: أنا سأحدثكم كعالم وخبير في البرمجة اللغوية العصبية، وأتى بأرقام، وأوحى بأشياء ومزاعم كثيرة، لكن حسن حنفي قال: أنتم تظلمون الرجل، لأنّ الأخ هو داعية وليس عالما، والداعية هو رجل جدل لا برهان. ومع أنّني تفهّمت مُراد الفقيد حسن حنفي، إلاّ أنّني أحببت أن أستفزه قليلا، حين أجبت عن بعض التعليقات، قلت: إنّ عهدي بالدكتور حسن حنفي، أنّه ليس على مذهب محمد عابد الجابري في ثلاثية البنيات الخالصة: البرهان والبيان والعرفان، فلا شيء من تلك الثلاثية خالص، فلا يوجد برهان يخلو من جدل ولا جدل يخلو من برهان.
والحقّ، هو أنّ حسن حنفي كان بخلاف غيره يميز بين العالم والداعية، بين الكادح على طريق التمثّلات المدرسانية وبين أهل التفكير والابتكار. وتظل نظرته للعقل والواقع تمتاح من عمق نزعة هيغلية دفينة، يكون الواقعي هو العقلي والعكس، ومن هنا، احتدم بيني وبينه نقاش على هامش ملتقى حول المناهج ببيروت؛ كنت أتحدّث عن التسليم المنهجي بدل الشك المنهجي، ولكنني استعملت؛ والحقيقة هي أنّ الأمر هنا أشبه ببرهان الخُلف، لكنه ردّ بقوة: أنا لا أسلم بشيء قبل أن يسلم به العقل، كان سوء تفاهم نابع من اللغة والآثار السلبية للألفاظ، وجب استحضار علم نفس المصطلح وآثاره. قلت له: لنتصور أنّك تنوي الدخول إلى غرفة مغلقة، وقيل لك: انتبه ستجد فيها سنورا مزعجا، فأنت قد لا تأبه بالخبر وستغامر طالما أنّ وجود السنور لا يشكّل أي خطر محتمل، لكن ماذا لو قلت لك أن داخل هذه الغرفة وحش كاسر، ما أن تفتح الباب حتى يلتهمك؟ حتما ستحتاط، وسيكون الاحتياط موقف عقلي. يبدو أنّه اقتنع واستمر الودّ.
محطات كثيرة بتفاصيل تغني الذّاكرة، كنت أتعامل مع الفقيد بوصفه شيخ المفكرين العرب، الرجل الذي كان يجيبك حتى وهو طريح الفراش، وهو واقعي بالفعل، لأنه لا يستهين بتفاصيل الإنسان والأشياء. نموذج لمثقف منخرط في هموم المجتمع وقضاياه، ليس مفكر الصالونات والسهرات، بل هو رجل المواقف. وفي عشاء جمعنا في باكو ، دُعينا إليه من قبل بعض المسؤولين، كان النقاش محتدما، كانت فرصة لمسؤول في جامعة الدول العربية أحبّ أن يكمل نقاشه معي، لا سيما وأنّني داخلت معلّقا عليه؛ كان النقاش طويلا، ولكنه نقاش ودّي في ظاهره حامي الوطيس في داخله، وعلى عادته، كان د. حسن حنفي يتابع الجدل ولكنه لم ينبس ببنت شفة، تلك خاصية أخرى، وهي أن حسن حنفي ومع إيمانه بالجدل في بناء الرأي والموقف إلاّ أنّه كان يتجنّب الاشتباك والفتنة. لكنه في المنصة كان قد عبّر عن آرائه بكل وضوح وصرامة. أحسست أنّه لم يكن معجبا بالمسؤول في جامعة الدول العربية، حيث فضّل تجاهله عنوة
غاب د. حسن حنفي عن الأنظار ولم يظهر إلاّ لماما، تمكن منه المرض والتعب، ولكنه بدا مقاتلا حقيقيا، لأنّه لم يفقد قدرته على التركيز والتفكير، وهذا ما سنكتشفه حين ألقى محاضرة قيمة بدعوة من المجمع الفلسفي العربي، والتي تخللها نقاش حيوي، لمفكّر لم يفقد طيبته ولا تواضعه. وهذه خاصية وجب الوقوف عندها مليّا، لأنها ليست معطى بديهيا، بل إنّ التواضع خاصية المفكّر الحقيقي، فهو رجل مشغول بتنمية الأفكار لا بالعلوّ في الأرض، لا يستقوي بأي اعتبار آخر في عرض شخصيته غير الفكر والتفكير، ولا يلوذ بأي حيلة من حيل زمن التّفاهة لبناء رصيده كمثقف عضوي يعبر عن قناعاته التي اختطها لنفسه وليس تمثل قناعات بحسب ما تمليه المصالح والسياسات الثقافوية. هذا النموذج من المثقف العضوي يتعرض للانقراض في المجال العربي، وإنّ وفاة مفكر من طراز حسن حنفي هو خسارة لمفهوم المثقف العضوي، لأننا سنواجه مستقبلا خطيرا سيهيمن عليه المثقف المزيف، وستحكمه التّفاهة، حيث ستصبح الثقافة تمرينا للدعاية والإدعاء.
وإذا كان حسن حنفي مثقفا عضويا يؤمن بالجدل والنقاش العمومي، فهو من حيث التحقيق والعلم، عالي التكوين، متقن لفنّه، ولقد لمست مرارا كيف أنّه يتوقف عند أدق المهملات في تاريخ الفلسفة، حتى أنّ تأويله الذي يأخذ مناحي تبدو أحيانا غريبة، تؤكد بالمفهوم إتقانا للأصل، وقد قدّم عرضا مهمّا لتاريخ الأفكار وقدم ترجمات راقية أهمها رسالة في السياسة واللاهوت لسبينوزا، كما ترجم لسارتر وقدم عروضا تأويلية لفيخته وهيغل وهوسرل.
يؤمن حسن حنفي بأنّ التراث العربي والإسلامي فكّر في كل ما فكّر فيه الغرب، وهو في منحاه المعتزلي يبدو مناكفا لكل ما هو صوفي وعرفاني، من منطلق نظرة كلاسيكية للعقل شكلت محورا لكل مطارحاته؛ لم يكن موقفه من العرفان نابعا من خلفية سلفية تعقلنت بالاستدراك، مثل المرحوم محمد عابد الجابري – وقد جمعهما حوار مهمّ يومها : حوار المشرق والمغرب- ولكنه آثر أن يكون معتزليا نظّاميا، وهو لا يرى في العقلانية الغربية سوى امتداد لهذه النزعة العقلانية على طريقة سلفه رفاعة الطهطاوي الذي توسّم في تلك المظاهر ما يبدو تطبيقا لنظرية المعتزلة في التحسين والتقبيح العقليين.
وسنجد أنّ حسن حنفي سيخوض في حقل آخر، وسيعمل على تأسيسه من خلال وضع مقدّمات في نقده: علم الاستغراب، وذلك لأنه آمن بأنّنا نستطيع أن ننجز علما عن الغرب مقابل الاستشراق. أصدر هذا العمل في بدايات التسعينيات، وكانت فرصة سانحة لأقف عنده بالتفصيل، متتبعا لكل مناحي توتّراته، مستمتعا باستيعابه. ربما آنئذ لا أزعم أنّ ما قمت أيضا بإبدائه من وجهات نظر مخالفة في بعض المحطّات ليس بالضرورة صحيحا، ولكن القيمة الفكرية لنقد النصوص الكبرى، هي تمرين كبير، وتعزيز للحياة الفكرية. قلت بأنّ رفض النقد أيّا كان هو اعورار في بنية العقل، وقد رأيت الكثير من أهل الفكر يزعجهم أن تعبّر عن رأيك المختلف، لا سيما المجرد عن الكيدية والنابع من حيثيات موضوعية، لكنك قلّما تقف عند حالة من التسامح التي تجعل المنقود لا يحقد على ناقده؛ وللإنصاف هناك عينات لمست منها هذا النوع من سعة الصدر وعدم استحضار سوء النّية في التعاطي مع النّقاد: محمد عابد الجابري وحسن حنفي، لقد تعاملا معي بتسامح وتقدير على الرغم من نقد نصوصهما حتى الثُّمالة، بخلاف آخرين خاضوا في النقد حتى الثُّمالة، لكنهم ما أن اُنتقدوا حتى أصبحنا أمام ملحمة من اللُّتيّا والتي.
على امتداد أكثر من عشرين صفحة، تناولت مقدمات في علم الاستغراب، حيث عنوت لها: “مقدمة في علم الاستغراب؛ محاولة في الخروج من المحيط، ولكن”، مشيرا إلى ” أن دراستنا هذه تحاول مواكبة حسن حنفي في رحلته هذه أخذا وردّا”، وكان من بين تلك الملاحظات ما يلي على شكل شدرات:
_ لا غرو أن د. حسن حنفي في البداية، كان صريحا، وصاحب جرأة وهم حقيقيين. نقول – وتلك وجهة نظرنا – إن حسن حنفي كان يمتلك الشجاعة الكافية والثقة الكاملة في النفس، لكي يخرج عن الفتنة الأوروباوية بعزة الأنا، وإن كان أحيانا يدخل بالأنا إلى عمق الغرب.
_ هناك قضية تميز رؤية حنفي للحضارة الإسلامية، هي كونها -وخلافا- للطيب تيزني، ذات اتجاه مركزي، ماهوي، والسمة الطردية التي يأخذ بها تيزني، ليست إلاّ رديفا لتاريخانيته الماركسية. والطردية هي صفة التراث الأوربي. ومن هنا لابد من التوسع في دراسة التسلسل التاريخي للتراث الغربي، ذلك لأنّ هذا الأخير يعتبر “تطورا صرفا” دون “بناء”.
_ وقد نعترض على حنفي في قضية البنية والتاريخ، ونقول إن هناك بنية، ولكنها تتجدد باستمرار وتتلون أبدا، فتأخذ أشكالا مختلفة يمليها الواقع والتاريخ. إنّ التاريخ هو مهد نمو البنية وتطورها، والتطور هو أحد خصائص البنية هذه. فلا يمكن أن يجري سوى في فضاء التاريخ، فالتاريخ إذن خاصية بنيوية.
_لا أريد أن أنكر المنهج البنيوي إطلاقا، غير أنني أردت فقط توضيح أن الادعاء فقط لا يكفي للتحرر من الآخر، ولذلك سوف يتوضح أن العلم المستقل عن الأنا والآخر هو القادر على حلّ هذه الأزمة.
_ ثم إن ما رآه حنفي بنية في الوعي الأوربي، ليس بنية خاصة بذلك الوعي، بل هي بنية كل وعي بشري عبر تاريخ من الإنتاج العقلي، إن عاملي الهدم والبناء هما خاصيتان موجودتان في كل وعي احتضنته الحضارة الإنسانية، وكذلك جانب الغائية(…) فالبنية العامة تتحول في استغراب حنفي إلى بنية خاصة.
استوقفتني عبارة لحسن حنفي في علم الاستغراب يقول فيها بالحرف: ” يمكنني أخذ كل فلاسفة الغرب وأضمهم في طابور عرض وأكون أنا قائدهم، وأحركهم وأستعرضهم في حركات وتشكيلات وتحيات كيفما أشاء وطبقا لاستراتيجيتي وخططي وأهدافي”.
ما استوقفني يومها هو أنّ حسن حنفي كان يبحث عن تثبيت الأنا، لكنني يومها كنت مأخوذا بتثبيت الحقيقة، وهي قيمة تتعالى على الأنا والآخر معا. إن كنت سأؤاخذ الآخر على غايات وأهداف معينة، فلا يمكنني أن أقوم في المقابل بالأمر نفسه. موقف غير عقلاني وليس فيه من العدالة شيء. قلت حينها: نعم لو كانت هذه فقط لكفت في الكشف عن البعد الأيديولوجي لما كان يفترض أن يكون علما للاستغراب، وإلا فبأي منهج محايد وبأي معيار يتم عرضه وتشخيصه؟ فاستراتيجيا حنفي وأهدافه في الاستغراب قد تقابلها استراتيجيات وأهداف أخطر، وتصبح القضية في نهاية المطاف أهداف ضدّ أهداف، وسيجد حنفي نفسه في صراع مع الآخ وفي سنده أنا وهمي غير محدد، وتبقى المشكلة: بأي منهج درس حنفي الغرب؟ إنه قرأه بدافع الشعور بالذّات، والشعور بالذات ليس منهجا في المعرفة، طريقة في علاج النفس وليس منهجا في المعرفة. وسأتساءل يومها: ثم ماذا؟ والجواب: إنّ الخروج من المحيط ليس خروجا فلسفيا ، إن الحديث لا بدّ أن يجري في دائرة الثروة والواقع السياسي، أن نضع قواعد علم في الاستغراب نقارب فيها قضية الثروة والتدبير السياسي والهيمنة والاستكبار العالمي للمركز. إنّ الأنا لا ولن تتحرر من تصورات الآخر إلاّ بتمرد الأول عن أوهامه، إنها العوامل المساعدة التي تربط الآنا بالآخر كما نلاحظها في أجهزتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وغريب كيف ينسى حنفي أن تلك التحولات الفلسفية الكبرى كانت لها أرضيتها في الواقع. إنها قراءة تميل إلى التجريد خارج العياني، قراءة الغرب بأدوات الغرب وبشامّة عروبية، تحتاج بذلك إلى استغراب جديد: استغراب الاستغراب.
كان ذلك مطلع التسعينيات، ولكن حينما أعود إلى محاولة الفقيد حسن حنفي أشعر بقيمة مفكّر يستقلّ برأيه، وكمثقفي عصره، هو يؤمن بالعودة إلى الذات، نظير صديقه علي شريعتي، حيث كان معجبا بطروحاته لا سيما في “العودة إلى الذّات” وأيضا اهتمامه بأعمال الشهيد باقر الصدر “فلسفتنا” و”اقتصادنا”، أي ما يجري مجرى العودة إلى الأنا؛ ربما وجب وضع الأمور في سياقها، فخلافا للعروي، كان حنفي يستحضر مشاعر عصر الاستعمار، يدرك بأنّ ذلك الشيء الذي محقه الاستعمار فينا وجب أن يعود، وجب الثقة في التراث، ولكن في تأويل التراث بدأت مرحلة أخرى من النزاع الأيديولوجي العربي.
أستطيع القول، بأنّ حسن حنفي مثال لمثقف يصعب تصنيفه حسب ثلاثية العروي في الأيديولوجيا العربية المعاصرة: الشيخ والليبرالي والتقني؛ ذلك لأنّ حنفي هو رجل حاول أن يستوعب كل الدعوات، ويعيد إنتاجها لصالح موقف العقل؛ والعقل هنا كما ذكرنا يصبح هيغليا هو الواقع؛ فهو من حيث الدعوة يدعو إلى الخروج من الانفعال إلى الفعل، من العقيدة إلى الثورة، من الفناء إلى البقاء، من النص إلى الواقع، من المتعالي إلى المتداني…هاجس الواقع جعله في معركة مع التقليد، وكان من المؤسسين لعلم كلام جديد يقوم على بارادايم الثورة والواقع والشعب؛ لقد سخّر كل شيء للراهنية دون أن يلتفت للآثار التي يتركها الجدل، لأنّ الغاية التي سخّر لها الفقيد كل هذا العمر من التفكير هو مواصلة سؤال النّهضة والتغيير وخلق حالة من التركيب لكل ما من شأنه تيسير الوصول إلى إحداث الثورة. وسيظلّ مصرّا على هذا التأويل، حيث بدت نظرته للتغيير والثورة تتجاوز حتى ذلك الغرب الذي نهض وتغير دون أن يغير في بنية المشاعر والانفعال والوجدان. وأرى في كل ذلك تأثير الوضع العربي وانحطاطه وتخلفه والآلام التي خلفها الاستعمار والتي ظهرت في ردود فعل حسن حنفي ومشاريعه التي يتعين قراءتها في هذا السياق، باعتبارها رفض جدري للهيمنة والاستبداد والاستعمار.
إن كان هناك من تكريم لفقيد الأيديولوجيا العربية، فهو مواصلة تحليل ومقاربة مشروع حسن حنفي، بالكيفية التي كان هو حريصا عليها؛ الصلابة في اتباع ما يبدو حقيقة. وكان أسلوب حنفي يتمتع بالوضوح، وهو رجل بيان حتى أنّه يحوّل الصناعة الفلسفية إلى ضرب من الإنشاء الماتع، بخلاف من يجعلون من الإنشاء صناعة متصنّعة.
ترجّل هذه الأيام مثقفون كُثر، وكان رحيلهم مؤشر على منعطف كبير ستواجهه الثقافة العربية، انقراض الجيل الأوّل، وبداية جيل فاقد للبوصلة.
سيظل الفقيد عنوان مرحلة مهمة من التاريخ الذهني العربي، ستفقده الساحة العربية، وسيتوارى بفعل سنة الحياة إلى الذّاكرة، وربما آن الأوان لإعادة قراءة هذا المشروع من خلال السياق العام للتحوّلات الجديدة. لقد كان رحمه الله واضحا في رفض الرجعية ومشاريعها، ومع أنّ هناك محاولات لاستغلال إسمه في بعض الأنشطة الرامية للهيمنة على العقل العربي، إلاّ أنه ظلّ مستعصيا على الاحتواء. رحم الله مفكرا لم يُبق في جعبته من جهد إلاّ وصرفه في سبيل التفكير في الأمة وللأمة، منقطعا للمعرفة، وذلك ما يجعله مثالا لمثقف عضوي لم يتنكّر لقضايا الأمة والمجتمع حتى في ذروة الشيخوخة والمرض.
ادريس هاني:22/10/2021