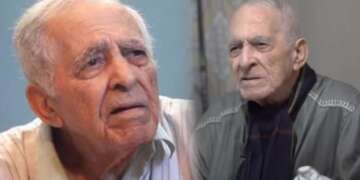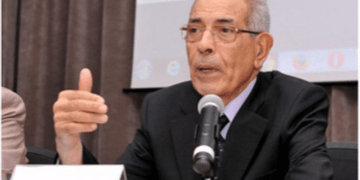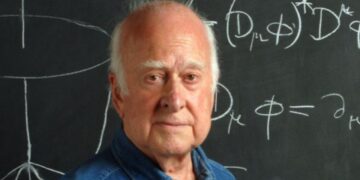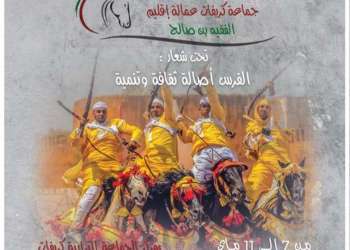مصطفى المنوزي
كنت دائما اريد إثارة نقطة مهمة حول حدود تواصل اليسار كتنظيمات وفعاليات سياسية وفكرية مع تنظيمات إسلامية ، جماعة العدل والإحسان كأفضل نموذج من الناحية النسبية لدى المتحالفين المفترضين ، لما لذلك من أبعاد وآثار مهمًة ومثيرًة للتفكير.؛ ذلك أن الحوار بين الحقوقيين أو المحامين اليساريين والعدليين المحامين قد يكون أسهل وأكثر توافقًا، نظرًا لأن مجالهم المهني يتعامل مع قضايا قانونية وحقوقية ومهنية ونقابية ، يمكن إيجاد أرضية مشتركة حولها، بعيدًا عن الانتماءات السياسية والفكرية. فالحقوقيون، في النهاية، يتعاملون مع مبادئ القانون والعدالة التي قد تكون قابلة للتطبيق بشكل حيادي بغض النظر عن المواقف السياسية.
لكن عندما يتعلق الأمر بالسياسيين والمثقفين، تصبح المسألة أكثر تعقيدًا ؛ فالسياسيون عادةً ما يسعون لتحقيق مصالح وبرامج حزبية تتأثر بشكل كبير بالإيديولوجيات التي يؤمنون بها ، ومن جهة أخرى، المثقفون يختلفون أيضًا في آرائهم حول القيم الأساسية مثل الحرية، الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، ويصعب أحيانًا التوافق بين هؤلاء الذين يحملون رؤى مختلفة بشكل جذري. لذلك قد يكون الحوار بينهم ممكنًا ولكن ليس من السهل أن يتم بناء تحالفات أو توافقات سياسية وفكرية دون المساس بالمبادئ الأساسية التي يتبنونها.
ليطرح السؤال : هل يمكن للمثقفين والسياسيين أن يتجاوزوا الاختلافات الإيديولوجية ويحترموا مساحة الحوار؟ وهل الحوار سيظل فقط على المستوى التقني أو القانوني بعيدًا عن الأبعاد السياسية العميقة؟
إن الأمر يثير مسؤولية تاريخية جسيمة ، خاصة وأن التحالفات لا تكون تجاه التناقضات الرئيسية المشتركة فقط ، أي تجاه العدو الطبقي أو النظام السياسي الحاكم أو الأجنبي الخارجي ، وإنما ضد التحالف يتم بالأساس في مواجهة التناقضات الثانوية هنا وهناك ، مما يؤكد سوء التحليل وترتيب التناقضات وسوء تدبير التحالفات والأولويات . ولذلك فأنا لا أرفض ولا أستغرب من ظاهرة تحالف تيارات التطرف والجذرية ، إلا من زاوية توافقهم على تكفير وتخوين المقاربات الإصلاحية والإعتدالية غير الراديكالية والمتطرف وتصنيفها في نفس خانة النظام الحاكم ؛ وبذلك فهي ظاهرة يسراوية إنتهازية وخطيرة ، وعلى الجميع قراءة تاريخ الإسلام السياسي ، فكم من تحالفات تكتيكية تحولت إلى خيارات استرتيجية . وبالتالي فهي ظاهرة معقدة تتطلب تحليلًا دقيقًا لفهم أبعادها وآلياتها. ويمكن تفسير هذه الظاهرة من خلال عدة عوامل، منها:
1. التقاء المصالح المؤقتة: فقد تتحالف تيارات متطرفة وجذرية من خلفيات إيديولوجية مختلفة بسبب وجود مصلحة مشتركة مؤقتة، مثل مواجهة عدو مشترك أو نظام سياسي معين. هذا التحالف قد يكون تكتيكيًا وليس استراتيجيًا، حيث إنه يركز على هدف محدد دون أن يعني بالضرورة تقاربًا فكريًا أو أيديولوجيًا. ولكن ما هي الضمانات خارج التوافقات الهشة وغير المبدئية ؟
2. الاستقطاب السياسي والاجتماعي: ففي ظل بيئة سياسية واجتماعية شديدة الاستقطاب، قد تدفع الظروف المختلفة التيارات المتطرفة إلى التقارب، خاصة إذا شعرت بأنها مستهدفة أو مهمشة من قبل النظام الحاكم أو القوى السياسية المهيمنة. ولكن ما قولنا من الانسحاب من حركة 20 فبراير دون سابق إخطار ؟ ونفس السؤال نطرحه في النقطة الموالية ، خاصة في ظل هساشة اليسار تنظيميا /كميا !
3. الاستفادة من الفرص السياسية: قد ترى التيارات المتطرفة في التحالفات فرصة لتعزيز نفوذها السياسي أو الاجتماعي، خاصة إذا كانت هذه التحالفات تتيح لها الوصول إلى جمهور أوسع أو تحسين صورتها العامة.
4. التأثير الخارجي : في بعض الأحيان، قد تكون هناك قوى خارجية تدعم أو تشجع تحالفات بين تيارات متطرفة لتحقيق أهداف جيوسياسية معينة، مما يعزز هذه الظاهرة. وقد لاحظنا أن دول عربية كثيرة عانت من هذه الشبهة ، في حين لم نحسم النقطة في المغرب ، ولا زالت السرديات الأمنية تشتغل كحقيقة إعلامية ، وقد حان الوقت لإعادة ترتيب العلاقات ودمقرطة أسسها بناء على قاعدة الإختلاف في وضوح افضل من الإتفاق في غموض ، وعلى أساسه بالنسبة ينبعث السؤال المفترض حول حدود تواصل اليسار مع تنظيمات إسلامية مثل جماعة العدل والإحسان، لأن الأمر يعتمد على طبيعة الحوار والأهداف منه؛ فالحوار بين الحقوقيين أو المحامين قد يكون أسهل بسبب التركيز على القضايا القانونية والحقوقية التي يمكن أن تكون محايدة نسبيًا. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالسياسيين والمثقفين، فإن الحوار يصبح أكثر تعقيدًا بسبب الاختلافات الإيديولوجية العميقة ، في ظل غياب أية ضمانات في مجال يتماهى فيه السياسي مع العقائدي و حيث تنتعش النزعة الذيلية والنزعة الإلحاقية تبادليا ؛ في سياق التنازع حول ” من يقود من ” في تجاذب كمي وتقاطب أغلبي تختلط فيه بوصلة الإنتماء مع قبلة الولاء .