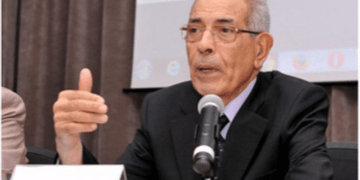مصطفى المنوزي
جوابا على مطلب تجديد النخب ، بادرت مؤسسة من أهم آليات المحاسبة والحكامة ، وهي المجلس الأعلى للحسابات إلى نشر تقرير يبرز جانبا من ممارسة يعتبرها شاذة ، ليس عن سياق إحترام القانون ، ولكن في علاقة المزاولة الحزبية مع دفتر التحملات المصاغ عبر تاريخ التسويات المبرمة بأسقف متدرجة منذ ، على أقل تقدير ، منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي ، بين القصر ومن تبقى من القيادة التي أفرزها المؤتمر الوطني الرابع للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ، والمنعقد في ظل ظروف سياسية وتنظيمية خاصة ، تختلط فيها الأسباب والنتائج والمسؤوليات ، وتبرز فيها التداعيات في صيغة مفارقات ، من بينها توتر علاقة القيادة التنفيذية للحزب ( الكاتب الأول على الخصوص ) مع الدولة ( القصر خاصة ) ، هذه العلاقة التي كانت أحد الأسباب المباشرة لما حصل في إجتماع الثامن من ماي 1983 ؛ ومانتج عنه من مشروع قطيعة توجت بعد عقد من الزمن ” الحزبي ” بالقطيعة التنظيمية ، فتحولت التناقضات الثانوية داخل الحزب إلى رئيسية ؛ استحال معها إصلاح ما يمكن إصلاحه ؛ وكانت محطة المؤتمر الوطني الخامس للحزب سنة 1989 غنية بالدلالات والمؤشرات . ظل الحزب يحمل معه بوادر إنشقاقات أخرى ، نزلت خلفيات الصراع من المستوى الفكري الإستراتيجي إلى درجة صار المهيمنون ” سياسيا ” على التنظيم والأجهزة هم المتحكمون في مسار الحزب وخياراته ؛ وتم اختزال استراتبجية النضال الديموقراطي في مجرد تكتيكات انتخابية ، توجت بخيار المشاركة السياسية في حكومة إئتلافية ، سميت إعلاميا ” حكومة التناوب التوافقي ” بقيادة حزب قضى نصف قرن في المعارضتين ( المتوازيتين ) المؤسستية والجذرية . هذه التجربة التي لم تصمد أمام قوى المحافظة ومقاومة التغيير ، وبنفس القدر ظلت بوادر التوتر تتناسل إلى أن انعقد مؤتمر الحسم السادس ، فانسحب تيار النقابة وشكل حزبه الخاص به ، كما إنشقت قيادة الشبيبة والنخبة المساندة لها ؛ فكانت مؤشرا على ضعف حلقة تيار اليوسفي ، تم إستغلاله للانقلاب بسهولة على ما سمي بالمنهجية الديموقراطية ، والذي هو في العمق إنقلاب على ميثاق تم نقضه ، يتعلق بتسوية سياسية غير معلنة بين العاهل الراحل والمجاهد ، تسوية لم يبرز من مقتضياتها سوى ضمان إنتقال سلسل للحكم من ملك إلى ملك ، وهو التناوب الوحيد الذي حصل من والد لولده . ليطرح السؤال حول رد فعل الحزب بعد رحيل الوزير الأول من الحزب والوطن ، دون تكريم أو محاسبة ! وبأي شروط واصلت الخلافة الحضور داخل حكومة جطو ؟
وهنا أسمح لنفسي باستنتاج يغني ( مؤقتا !!) عن البحث في أسئلة أعمق ؛ مرتبطة بالحالة التي وصل إليها المشهد الحزبي ؛ بل بلغته الدولة نفسها !
لذلك لا أخفي شعوري القوي بأن الدولة حاولت ولا زالت ، خلال العهد الجديد ، طي صفحة الماضي ، ولكن بالقطع فقط مع الحركة الإتحادية ، كتاريخ وكمشروع مجتمعي ؛ ولا تهمها كينونة حزب القوات الشعبية كتنظيم ونخبة سياسية ” وريثة ” ، وهنا وجب التمييز بين ورثة الحزب وبين ذوي الحقوق التاريخية والسياسية ؛ فرغم إيماننا بأن علاقة الحزب تاريخيا لم تخرج أبدا عن تاريخ توترات مصحوبة أحيانا بعنف وعنف مضاد ، وأحيانا يوازي خيار التسويات ؛ غير أن الحزب لم يبلغ أبدا مستوى قبول مساومته بالرشوة السياسية أو الريع ؛ رغم مبادرات العقل الأمني في هذا المجال ؛ وما محاولة وزارة الداخلية لتوريط الحزب في عملياتها التدليسية خلال بعض الإستحقاقات ( التشريعية على الخصوص ) ، من خلال تزوير النتائج لفائدة ” بعض الأطر ” المفيدة ل”” السلم الإجتماعي ” ، طبعا دون تناسي الإختراقات التي تمت على مستوى ” العمل الجماعي / الترابي ” ، والذي كان فرصة وتمكينا للإثراء والإرتقاء ؛ وهو في جميع الحالات لم يكن متافقما كما هو عليه الحال اليوم ؛ إنه ازدهار في سياق تدشين دولة الرخاء ، ولم يعد أي رهان ” مطلق ” في العلاقة مع مطلب التصحيح أو الإصلاح ؛ اللهم بعض الرجاء والتمني أن يتم إنقاذ حلم المغاربة من الإجهاض ، على الأقل في قطاعي العدل والأمن ، باعتبارهما قلاع ينبغي المزيد من التحصين من عدوى الفساد والإختراق . صحيح هناك مبادرات من الدولة في هذا الإتجاه ، ولكن لا ينبغي إختزال الإصلاح في مجرد تهذيب أوتشذيب أغصان الفساد ، بل لا مناص من إستئصال مظاهر الإستبداد وجذور الإفساد ، وهذا لن يتأتى سوى بسن استراتيجيا عدم الإفلات من العقاب ، ولأن للقضاء حاسم في التخليق ؛ فإنه يطرح بإلحاح مطلب تأهيل السلطة القضائية بمزيد من إستقلالها عن السلطة التنفيذية وكافة السلطات الموازية ، من إعلامية ومالية وسياسية . أما عن فرضية بحث الدولة عن بدائل من نفس العينة ؛ فظني أن العقل الأمني لا يفكر تكتيكيا لحاضر العهد الجديد فقط ، ولكن بدرجة أقوى في مستقبل أي إنتقال لم تعد فيه أية قوة توازي حجم الإتحاد الإشتراكي يوم كانت له إمتدادات في العمل الجماهيري والمؤسساتي والعلاقات الدبلوماسية ؛ لذلك وجب التفكير الجماعي ليكون الكل مشاركا في أي تحول ولو بالرقابة أو المتابعة النقدية ؛ فالأمر تجاوز أسئلة مصير الأحزاب في العلاقة مع مطلب الديموقراطية ، إلى أسئلة حيوية مرتبطة بالكينونة العظمى للوطن وموقعها في الخريطة العالمية ، في ظل التحولات المترددة أو المستحيلة .