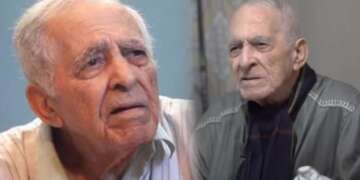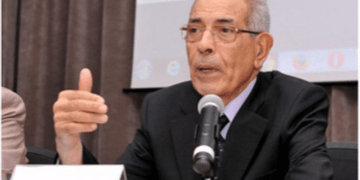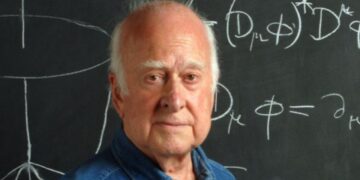محمد فارس
رأينا في مقالة سابقة على أنّ جائحة [كورونا] قد أعادت إلى الأذهان قيمةَ وضرورةَ العِلم، وأنّ الأمّةَ التي ستستحقّ البقاء والحياة، هي الأمم التي ترعى العلم، وتستثمر فيه وتشجّع أهلها على تعاطيه، وأنتَ ترى الآن أنّ الأمم التي أنتجتْ لقاحات ضدّ هذا الڤيْروس، إنّما هي أممُ العِلم والعلماء والمختبرات والجامعات، وما نحن اليوم إلاّ متسوِّقون لهذه اللّقاحات التي ستكلّفنا المليارات على حساب التنمية وسنضطرّ لا محالة إلى الاقتراض من بُنُوك جَشِعة، ومن مؤسّسات نقدية سَبُوعية، لأنّنا لم نهتمّ في سياساتِنا بالتّعليم، والبحث العِلمي، وإنّما أموالُنا استثمرْناها في الحفاظ على امتيازاتِ حيازاتِ ذوي الامتياز، وأنفقْناها في تفاهات، ولم نطوِّرْ بها جامعات، ولم نَرْعَ كفاءات، ولم نشجّعْ إبداعات في مجال العلوم، والأبحاث لغياب سياسات عقلانية حتى وصلْنا إلى هذه النتيجة..
والآن، وأنا أتحدّث عن العِلم، فلرُبّما كان من واجبي أن أسأل الفلاسفة على وجه الخصوص لتحديد مفهوم [العلم] حتى يتسنّى لنا أن نقف على أهمّية العِلم في الأمم وسائر المجتمعات، وأن نقف وقفةً قصيرةً عند أشهر التّصوّرات الذّائعة للعلم؛ فما هو العِلم إذن؟ [العلمُ] هو الإدراكُ مطلقًا تصوُّرًا كان أو تصديقًا، يقينًا كان أو غيْر يقيني، وقد يُطلق على التعقّل، أو على حصول صورة الشّيء في الذّهن، أو على إدراك الكُلّي مفهومًا كان أو حُكْما، أو على الاعتقاد الجازم الـمُطابِق للواقع، أو على إدراك الشّيء على ما هو عليه، أو على إدراك حقائق الأشياء وعِلَلِها، أو على إدراك المسائل عن دليل، أو على الملَكة الحاصلة عن إدراك تلك المسائل.. و[العلم] مُرادِف للمعرفة، إلاّ أنّه يتميّز عنها بكونه مجموعة معارف متّصفة بالوحدة والتّعميم، وقد يقال إنّ مفهوم [العِلم] أخصّ من مفهوم المعرفة، لأنّ المعرفة قسْمان: معرفة عامية، يعني (Vulgaire)، ومعرفة علْمية يعني (Scientifique)؛ والمعرفةُ العِلمية أعلى درجات الـمَعرفة، وهي التّعقّل المحْض.. وإذا علِمْنا أنّ العلِم عند (أرسطو) هو إدراكُ الكُلّي، وأنّه لا عِلمَ إلاّ بالكلّيات، أدركْنا أنّ غايةَ العِلم هي الكشفُ عن العلاقات الضّرورية بيْن ظواهر الأشياء، وهي غايةٌ نظرية بخلاف المعرفة العامية التي تتقيّد بالنتائج العِلمية، وتظلّ بمعنى معرفة جزئية.. والعِلم هو علوم، ولكلّ عِلمٍ موضوع، ومنهج يميّزانه عن غيْره، إلاّ أنّ الفلاسفة يُصنّفون العلومَ المختلفة، ويرتّبونها صنفًا صنْفًا، فما هي هذه التّصنيفات؟
فمن تصنيفات العلوم في الفلسفة القديمة، تصنيفُ (أرسطو) الذي زعَم أنّ عقولَنا تطلب العِلمَ للاطّلاع، أو الإبداع، أو الانتفاع، ولذلك انقسمتِ العلومُ بحسب هذه الغايات الثّلاث إلى علوم نظرية كالرّياضيات، والطبيعيات؛ وعلوم شعرية كالبلاغة، والشّعر، والجدل؛ وعلوم عَملية كالأخلاق، والاقتصاد، والسّياسة.. وهناك تصنيفُ (ابن سينا) الذي قال إنّ العلوم نظرية وعَملية.. وتصنيف (ابن خلدون) الذي قسّم العلومَ إلى قسميْن؛ الأوّل: العلوم العَقلية؛ والثاني: العلوم النّقلية.. وهناك تصنيفات كلّ من (بيكون)، و(آمبر) و(أُوغِسْت كومت) وقد تضيقُ الرّقعةُ إذا نحن استعرضناها كلّها؛ فمعذرة! لكن في وُسعِكَ إطلاقُ لفظ [العِلم] على عِلم بعينه، أو على مجموع العلوم، والشّيء الوحيد الذي يُجْمِع عليه الفلاسفة، وكافة مؤرّخي العلوم، هو أنّ تقدُّمَ أيّ مجتمع إنساني، رهْنٌ بتقدُّم العِلم، والذي يهمُّنا هنا، هو العلوم الصّحيحة أو المضبوطة، يعني (Sciences exactes).. والفلاسفة فرّقوا بيْن العِلم الفِعلي الذي لا يؤخَذ عن الغير، والعِلم الانفعالي الذي يُؤْخَذ عن الغير، فأيُّ عِلمٍ نأخذ به اليوم؟ فالعلمُ كسْبٌ يحصُل بالنظر، والبحث المستمرّ، فهو عقْلي وعَملي؛ فالعَقْلي هو ما يحصُل بالنّظر، والتّأمّل؛ وأمّا العملي فيحصُل بالعمل، والبحث والتّجربة؛ فأيُّهما نمارس نحن؟
فالمستقبل هو للمجتمعات العِلمانية، وليس للمجتمعات العَلمانية (بفتح العَيْن) كما يريد لنا خدّامُ الأجندات الهدّامة، وببّغاوات الحداثة التي تنادي بالحرية الجنسية، وبإلغاء الإعدام، وبتحرّر المواطنين من أغلال الأخلاق والقيم.. المستقبل سوف يبتسم لأمم العِلم، وليس لأمم الطّرب، والرّقص، والغناء، حيث الـمُغنّي، مفْسِد الأجيال يحاط بالعناية، ويُستضاف في القنوات، ويدلي برأيه وكأنّه عالم أو فيلسوف، ويصيب كاشيهات بالملايين، فيما لا تقرأ بحوث عالمٍ جليل، أو فيلسوف حكيم، بل حتى [النِّت] أو الهواتف الذّكية، وهي أدوات تكنولوجية متطوّرة، صارت تُستعمل في تكريس التّخلف، وفي نشر الدّعارة، وفي سائر المناكر، فيما الكتابُ لا أحد يَقربُه، وقد علاه الغبارُ، واعتراه البَلْيُ، فصارت البيوتُ لا تعتزُّ بالكتب، بل تعجّ بالهواتف النّقالة التي تَنقُل التّفاهات، وتشيع السّخافات، وتَنشر الأكاذيب، وفي هذه الأجواء الموبوءة، يتحدّثون عن [الوعي]؛ فعلى من تكذبون، وعلى من تضحكون؟ فلو عاش [ماركس] في هذا العصر، لاستَبدلَ مقولتَه الشّهيرة: [الدّينُ أَفْيون الشعوب] بِـ[البورْطابل أفْيون الشُّعوب] وقد تساوى في إدمانه المتعلّمُ والجاهل.. يَرفعون شعار: [وَعْيك ينجّيك]، كلاّ يا سادة، بلْ [عِلمُك ينجّيك] لو كان هناك عِلم في أمّة خاصمتِ العِلم، ونبيُّها عليه الصّلاة والسلام يقول: [لمدادٌ جرتْ به أقلامُ العلماء، أَقْرب إلى الله من دَم الشّهداء] ودينُنا هو الدّين الوحيد الذي يحثّ على طلب العِلم من الـمَهْد إلى اللّحْد، أم نحن سائرون إلى اللّحد بسبب غياب العِلم؟