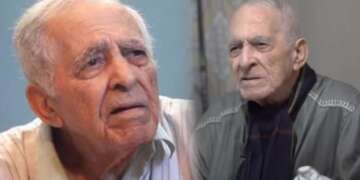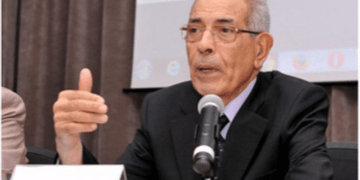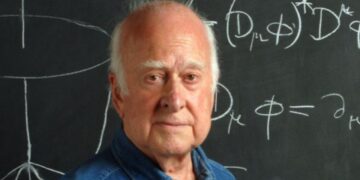ما الذي تَحقّق حتى يُحتفى بذكرى (20 فبراير) المشؤوم؟
محمد فارس
ما زلتُ أذْكُر ما حدثَ منذ عشر سنين خلتْ في (20 فبراير) عندما نُظِّمت مُظاهرات في ظلّ [الربيع العربي]، وكنتُ شاهدًا على ما حدَث في مدينة [طنجة] عندما صار الأشرار، والـمُجْرمون، واللّصوص، يكسّرون واجهات المحلاّت، ويَستولون على شاشات (بلازما) وعلى الهواتف النّقالة، وعلى كلّ ما وجدوه أمامهم، فيما آخرون عَمدوا إلى إحراق سيارات المواطنين، فكان الضّحايا المتضرّرون يشاهدون من شرفات منازلهم سيّاراتهم تَحْترق، وأطفالهم يَبْكون، ولكنْ عندما وصل المجرمون في شارع (محمّد الخامس) صادفوا أكبر مكتبة، غنية بالكتب والمجلّدات، فلم يَسْرِقوا الكتب لأنه لا حاجة لهم بها، فماذا فَعلوا؟ أضرَموا النّيرانَ في تلك المكتبة الضّخمة، وفي الصّباح استحالتِ الكتُبُ الثّمينة إلى رماد، عندها فقط، أيقنتُ بأنّ هذه ليست مظاهرة حضارية، وليس فيها أُناسِي مُتحضّرون، ولا علاقة لها بالفكر أو الثقافة، وأنّ (20 فبراير) كانت فرصة للغَوْغاء، وللجُهّال، ولأعداء الوطن، وتذكّرتُ وسط تلك النّيران المشتعلة وعمليات السّلب والنّهب ما حدث لمدينة [موسكو] سنة (1812).. فلماذا يُذَكّروننا بتلك الحوادث المؤْلمة؟ وعلى أيِّ أساس يتَذكّرونها ويحتفون بها وهي غيْر مُشرفة، بل تثير الخجلَ والسّخرية؟ ياه!
عندما غادر جيش [نابليون] مدينةَ [موسكو] مثقلا بالغنائم، والأَسْلاب، والسّرقات، صار بعضُ المجرمين واللّصوص الرّوس يَنهبون المحلاّت، ويَسرقون الأثاث، وكلّ ما تركه الجيشُ الفرنسي خلْفه، فارّا نحو الغرب، فعاد عُمْدة المدينة [روسْتُوبْشين]، فوجد بعضَ الرّوس قد تحوّلوا إلى لصوص ومجرمين، فأمرَ العمدةُ بإلقاء القبض عليهم قائلاً عندما حَضر شخصيًا عمليات إعدامهم: [لقد خانوا إمبراطورهم، ووطنهم؛ إنّهم لوّثوا شرف الاسم الرّوسي، وبسببهِم ضاعتْ (موسكو)، احْكموا عليهم بأنفُسكم، إنّني أهبهُم لكم، مزِّقوهم، إنّي آمركم بذلك].. كان هذا هو المفروض تجاه الخَونة من مُجْرمين، ومُضْرمي النّيران في [طنجة]؛ كان لابدّ من اتّخاذ قرار صارم وحاسم من طرف السّلطة آنذاك؛ هذا إذا كانت السّلطة هي مجموع إرادات الجماهير الممْنوحة للأشخاص المختارين من قِبل الجماهير باتّفاق علني أو ضمني.. كلّ هذا واضح في ميدان عِلم الحقوق، هذا العِلمُ المصنوع من اعتبارات عن كيْفية وجوب تنظيم الدّولة، والسلطة، ولكنْ هذا التّعريف يتطلّب توضيحًا إذا كنّا سنطبِّقُه على التاريخ..
ينظُر عالمُ الحقوق إلى الدّولة والسّلطة كما كان القدماءُ ينظرون إلى النار، يعني بصفتها شيئًا قائمًا في ذاته؛ أمّا بالنسبة إلى التاريخ، فالدّولة والسّلطة هما، على العكس، ظاهرتان بكل بساطة، تمامًا كما أنّ النار بالنسبة إلى الفيزياء، ليست عنصرًا، بل مجرّد ظاهرة.. وينتجُ من هذا الخلاف الأساسي في وجهات النظر بيْن التاريخ وعلم الحقوق، أنّ عِلم الحقوق يستطيع أن يتحدّث ما شاءَ عن الأسلوب الذي يجب اتّباعُه في تنظيم السّلطة، لكنّه يَعجز عن تقديم جواب عن المسائل التي يثيرها التاريخ، المتعلّقة بِمعيّن هذه السّلطة التي يغيّر الزّمان في أشكالها.. فما وقع في [طنجة] كان يجب أن يُعْتَبر عدوانًا على السّلطة، وعلى الـمُواطن، وعلى القانون، وكان يجب محاكمة اللّصوص، والمجرمين، وأَجْرم منهم مَن دَعوا إلى هذه المظاهرات، وما نتج عنها من سرقات، ونَهْب وإحراق لا ينساها التاريخ..
لكنْ هناك من الأعداء من ما زالوا يُحْيون هذه الذكرى المأساة ويَفْخرون بالمشاركة فيها وكأنّها محطّة تُشرف البلاد، وتُثلج صدورَ العباد، لكنْ اسْأَل من فقَد أملاكه أو أُحْرِقَ محلُّه، وسيّارتُه لتَعلمَ حقيقةَ (20 فبراير) السّيئة الذّكر.. في الواقع، لا يُدركُ الإنسانُ قوانيـنَ أية حركة إلاّ إذا عايَن وحدات وأحداثًا، لأنّ الدّوام الـمُطلق للحركة أمرٌ غامض بالنّسبة إلى العقل البشري؛ ولكنْ من ذلك التّقسيم التّحكُمي للحركة الدائمة، يَخلُق مع ذلك الجزء الأكبر من الأخطاء البشرية؛ و(الربيع العربي) بأحداثه، ووحداتِه المقَطَّعة أو المتواصلة كانت بلا شكّ من أكبر الأخطاء رغْمَ ما يحيط بها من هالة ويُفتَرض فيها من إيجابيات وهمية يُضخِّمها (الطّبالة) وشْعراء التّكسب، وخدّام القِوى الخفية، وعبيد منظمات هدْم العروش.. فهذا [الربيع] وما رافقه من أحداث واضطرابات كان وبالاً على الشّعوب العربية، بل إنّه أدّى إلى بروز ديكتاتوريات، وإلى استبداد أكثر ممّا عرفتْه الشعوبُ العربية خلال تاريخِها الأسود، وطيلةَ عشْر سنوات، وهذه الشعوب تزداد تخلّفًا، وفقرًا، وتعاني الظّلمَ والاضطهاد..