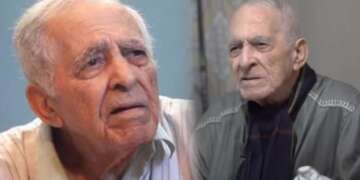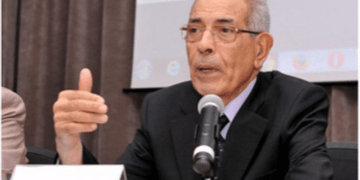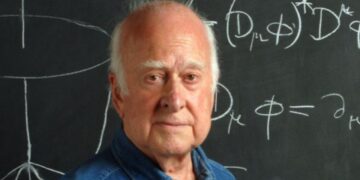د. رشيد لزرق
الدولة الاجتماعية هي بالضرورة دولة ديمقراطية، تقوم على أساس الحقوق والحريات، الدولة الاجتماعية ليست خيارا إيديولوجيا لحزب بعينه، أو لحكومة خلال عهدتها، بل هو خيار الدولة المغربية باعتبارها وظيفة اجتماعية مركزية من وظائف الدولة.
أما الحكومة الاجتماعية؛ فهي حكومة أساسها جعل السياسات العمومية بغاية الحد من الحالات والأوضاع التي تؤثر سلبا على كرامة المجتمع، على أساس رسم سياسة للحماية الاجتماعية، تساهم في تحقيق التنمية وتكريس العدالة الاجتماعية وضمان حق الجميع في التمتع بحماية اجتماعية شاملة ودامجة، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الوطنية لكل دولة.
لقد جاء التفكير في الدولة الاجتماعية في إطار الإجابة عما شهدته المملكة المغربية من تحولات وكشكل من أشكال التعاطي مع المطالب الشعبية في إطار هدف جماعي وهو بلوغ مصاف الدول الصاعدة.
فدستور 2011 كان بمثابة تفاعل ملكي مع مطالب شعبية جوهرها تحقيق الدولة الاجتماعية، مطالب تتمثل في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، لهذا فإن الهندسة الدستورية تؤكد المسار المغربي لتحقيق هذا المبتغى، وبهذا التنصيص الدستوري يكون المغرب قد أسس لهذا التوجه من خلال التأكيد على مرجعيته التأسيسية في منطوق الدستور المغربي لسنة 2011، حيث تم الإعلان من خلال ديباجته عن مواصلة المملكة المغربية إقامة مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.
وحدد نظام الحكم في الفصل الأول من الدستور “نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية”.
وبهذا تم دسترة الخيار الديمقراطي كثابت من ثوابت المملكة المغربية.
إذن التعاقد الدستوري جسد جدلية الديمقراطية والتنمية من خلال الجمع بينهما، إذ لا يمكن تكريس الديمقراطية إلا بتكريس التنمية. فالدستور المغربي يضمن الحقوق الاجتماعية والحريات، ومسؤوليات الدولة في تحقيق خدمات للمجتمع تتمثل في ضمان العدالة الاجتماعية والمجالية.
فالتنمية هي التي تبرز فوائد الديمقراطية وتجعل المواطن يحس بالكرامة والانتماء من خلال تكريس الدولة الاجتماعية الجامعة.
إذن قيم الدولة الاجتماعية تقوم على أساس الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
ومطلب الدولة الاجتماعية هو مطلب جماعي لا يهم الحكومة أو حزبا بعينه بل هو مطلب جماعي لتحقيق الدولة الصاعدة التي تستفيد من الجميع ويستفيد منها الجميع.
وإذا كان المغرب أقر التعددية الحزبية منذ أول تجربة دستورية سنة 1962 فإن هذه التعددية الحزبية لم تصل بعد للتعددية السياسية في ظل ما نعيشه اليوم من أزمة خطاب سياسي. ولا شك أن الحزب السياسي هو الأداة الحاملة لمشروع فكري وهو مدرسة للتربية السياسية للمواطن، ينخرط فيها ليتدرب على مساهمته في الشأن العام وعلى ممارسة حقوقه السياسية الأساسية، لكن تحقيق هذه المهمة بصورتها المثلى ليس بالأمر اليسير في ظل حالة الاضطراب التنظيمي الذي تشهده غالبية الأحزاب السياسية وحالات الانشقاق التي تعرفها، إضافة إلى ما تعرفه من أزمة خطاب سياسي و يزداد الأمر استفحالا في اتجاه الأحزاب للتحول إلى أحزاب الأفراد عوض أحزاب المؤسسات، وعليه يمكن القول إن ديمقراطيتنا مازالت هشة بفعل كون العمود الفقري للخيار الديمقراطي هو الأداة الحزبية الحاملة لمشروع فكري وذات تنظيم عقلاني للفعل السياسي، قوام هذا النموذج العقلاني السعي إلى تحويل الحزب السياسي إلى بنية جماعية متآلفة عضوياً، أي إلى عقل جماعي يتناقش فيه جميع الأعضاء حول قضايا الشأن العام.
والسؤال المركزي هنا في ظل حالة هذا الانفلات الحزبي (المبررة بحكم الواقع وحداثة التجربة الديمقراطية) هو بلورة خطاب ليبيرالي اجتماعي يجعل للفعل السياسي أحزاباً فعلية تنطبق عليها التسمية وتتسق مع المفهوم كما تحدد في العلوم السياسية.
وإذا كان السؤال المركزي في هذه المداخلة هو سؤال الدولة الاجتماعية وسؤال القيم وإشكالية الخطاب.
إننا نجد الكل يتحدث عن كون بلوغ الدولة الاجتماعية يمر لزوما بمواجهة ثلاثي الجهل والفقر والمرض. ولكن ما هي حصيلتنا في ذلك بعد أزيد من عقد على دستور 2011. ورغم ذلك يجب أن نقر أنه من الصعب رصد تدبير الحكومة الحالية التي جاءت في سياق إقليمي ودولي مضطرب أفرز انعكاسات اقتصاديـة وتأثيرا علـى المواطنين خاصة الفئات الهشة والفقيرة؟ وإلى أي حد ساهمت بعض الإجراءات المتخذة في تنزيل معالم الدولة الاجتماعية المتعلقة أساسا بالصحة والتعليم والتشغيل؟
-1 أزمة الخطاب السياسي
الغاية من الخطاب السياسي هو التواصل مع الجمهور؛ في توضيح كل القضايا بروح قوامها المسؤولية قصد توطيد الثقة، باعتباره وجه تدبير للشأن العام؛ وبما أن الحزب الذي يقود الحكومة حاز على ثقة المواطنين والمواطنات من خلال خطاب يقوم على أساس الليبرالية الاجتماعية وتشكلت الحكومة من ثلاثة أحزاب ليبرالية، لتكون الحكومة الحالية حكومة تشكل الحدث لكونها حكومة منسجمة أيديولوجيا، واحترمت الإرادة الشعبية باعتبار الثلاثي الحكومي هو المتصدر انتخابيا، يشترك في مقاربة الرؤية الاجتماعية على مستوى الخطاب الليبيرالي الاجتماعي. الشيء الذي يجعلنا نتوصل لكون أن هذا الخطاب الانتخابي تلقى القبول والاقتناع وحصل على مصداقيته في الانتخابات.
فيما عجزت المعارضة عن تشكيل تنسيق على مستوى الخطاب رغم أن تصدرها من طرف حزب اشتراكي ديمقراطي وباقي أحزاب اليسار، الأمر الذي كان من المفروض أن يساعد على مقارعة فكرية على مستوى الخطاب. اختلاف الرؤى للدولة الاجتماعية بين تكتل ليبرالي حكومي ومعارضة يسارية. يرفع مستوى الخطاب الذي يقوم على الإقناع والمدعم بالحجج والبراهين، بين الخطاب الداعم للسياسة الحكومية، والمعارض لها وفق لغة مسؤولة. غير أن تخلي أحزاب المعارضة وفق ظاهرة غريبة في المغرب أظهرت أن الوصول للحكومة بات غاية وليست وسيلة، مما أفرز انحطاطا في الخطاب وغياب التواصل الشفاف والمسؤول الذي يقوم على إيصال الخبر للجمهور بطريقة صحيحة ومقنعة.
فالحكومة أفرزت ارتباكا في تسويق السياسات المتخذة بخطاب شعبي شفاف مقنع للسياسات المتبعة للتحديات والمعضلات المحدثة والتخطيط من أجل تغييره يخاطب أفراد المجتمع، يسمع آراءهم، ومطالبهم، ومحاولة إيجاد الوسائل، والطرق التي تساهم في إشراكهم. مما جعل أطرافا من المعارضة تظهر كأنها مازالت لم تتخلص من صدمة انتخابات 8 شتنبر، وتريد الركوب على النفس الاحتجاجي باعتمادها خطابا شعبويا.
2- الفرق بين الخطاب الشعبي والشعبوي
الخطاب الشعبي يروم تبسيط المعطيات بغاية التواصل مع كل أفراد المجتمع، أما الخطاب الشعبوي يروم تحريف المعطيات بغاية مخادعة أو تهييج المجتمع وتقديم حقائق أخرى غير الموجودة والمتبعة من قبل أفراد معينين.
الخطاب الشعبوي القائم على الشرائح والفئوية؛ يتنكر للمسؤولية السياسية وينهج العنف اللفظي.
والحال أن الظروف الخاصة التي يمر منها المشهد السياسي تتطلب تعاملا خاصا، لا سيما من طرف النخب التي تقع على عَاتقها مسؤولية توجيه المجتمع؛ بغاية تحصين الخيار الديمقراطي، بدل لعب أدوار المتصارعين الذين تقودهم أهواؤهم ونزواتهم السياسية، الأمر الذي قد يؤدي للغرق الجماعي في ظل تعاظم أدوار شبكات التواصل الاجتماعي، وما نشهده اليوم من تعالي الخطابات الديماغوجية الشعبوية والفئوية التي يبدو أن وتيرتها تتصاعد كلما اقترب موعد الاستحقاقات الانتخابية، أو المحطات الحاسمة في تجاهل صارخ للمصلحة العليا للوطن وتغليبٍ سافر للمصالح الآنية الضيقة.
صحيح أن تلك الخطابات الشعوبية قد تجد صدى مؤقتًا لدى بعض الفئات، بسبب استخدامها لأسلوب الإثارة ودغدغة المشاعر والوعود السَّرَابِية البَرّاقة، لكنها لن تَنْطَلِيَ على الغالبية العظمى من الناخبين الذين راكموا من الرُّشد والنُّضج بحيث يعرفون جيدا أين تكمن مصلحتهم.
3- عشرية الخطاب الشعبوي
لا شك أن مستوى الخطاب السياسي انحدر إلى مستوى غير مسبوق مما أصبح ينذر بخطر مؤسساتي جراء انتشار العنف اللفظي وتدني مستوى النخب السياسية، مما جعل العديدين يحذرون من هذه الأزمة التي تنذر بأخطار جمة والبعض الآخر يعتبرها من تداعيات الثورة الرقمية.
4- مقومات الخطاب السياسي
داخل المجتمع هناك خطابات سياسية متعددة، خطاب سياسي داعم للحكومة يساند سياساتها المتبعة، وخطاب معارض احتجاجي يقوم على معارضة وتوجيه النقد للحكومة، والدفاع عن البرامج والاختيارات ذات الطابع الاجتماعي التي يتم وضعها من قبل جهة الحكومة. دور السياسي هو بث التفاؤل والأمل بالمستقبل، وإيجاد رؤية سياسية اجتماعية.
5- الخطاب المؤسساتي
هو الخطاب الذي يرتبطُ بالمؤسسات الرسمية كالحكومة والبرلمان والجماعات الترابية وباقي مؤسسات الدولة وينحصر هذا الخطاب على موضوع واحد، ويحتوي على تفاصيل مباشرة، وواضحة وعادة ما يلتزم بعدد صفحات قليلة.
6- مواجهة ظاهرة الشعبوية.
ظاهرة الشعبوية لها انعكاسات سلبية وهي وجه من أوجه أزمة الديمقراطية التمثيلية، عموما وتآكل ناخبي الأحزاب الرئيسية بسبب عدم تجديد الطاقم السياسي والأفكار؛ وتقلب المزاج الشعبي وتوجه الناخبين.
الأمر الذي يطرح كيف مواجهة هذه الظاهرة؛ ومن خلالها الشعبويين، هل يكون بالإقصاء أو بعدم الرد بالتقليل من فعلهم في المجال العام.
إن مواجهة الشعبويين بالإقصاء يجعل الشعبويين لهم شرعية الإقصاء ويصنعون من أنفسهم ضحايا ويقويهم من خلال الإيحاء بكون هناك موضوعات محرمة.
البديل الأنجع هو عدم إقصائهم أو معاملتهم كديماغوجيين أو منافقين، بل تقديم مقترحات مضادة حقيقية، إدانة التصريحات غير الديموقراطية وغير الأخلاقية، لا سيما الخطابات التقسيمية التي تستثني جزءاً من السكان تحت مبرر الحديث باسم الشعب.